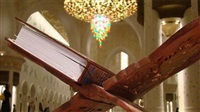اجتهاد القدماء والمعاصرين.. فرضية التجديد وإشكالية التقليد (3 - 4)
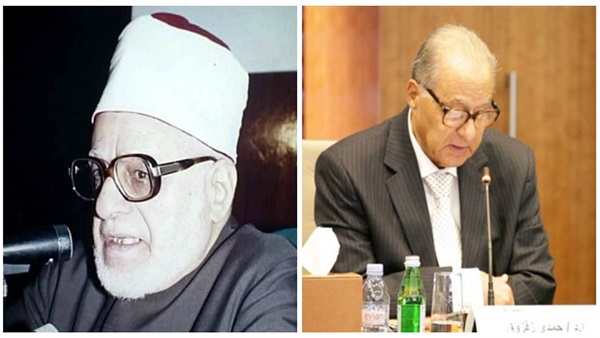
نُلقي في الجزء الثالث من دراسة: «اجتهاد القدماء والمعاصرين.. فرضية التجديد وإشكالية التقليد»، الضوء على اجتهاد المعاصرين، لنرى هل هو تجديد أم تقليد؟ وهل يوجد في عصرنا الراهن دوافع قوية للاجتهاد كتلك التي دفعت القدماء لخوض هذا المعترك؟ وفي حال وجود هذه الدوافع هل كانت همة الخلف شبيهةً بتلك التي تشبع بها السلف؟
للمزيد.. اجتهاد القدماء والمعاصرين.. فرضية التجديد وإشكالية التقليد (1 - 4)

ولماذا لا يسير المنهج الاجتهادي الذي أسقط به سهم المؤلفة قلوبهم، وضريبة الجزية المستنبطة أحكامهما من نصوص قطعية الثبوت والدلالة في استقامته ليسري على غيره من النصوص القرآنية مثل المساواة في الميراث وغيرها؟
للمزيد.. اجتهاد القدماء والمعاصرين.. فرضية التجديد وإشكالية التقليد (2 - 4)
المحور الخامس: اجتهاد المعاصرين.. تجديد أم تقليد؟
خاض الرعيل الأول من المسلمين معترك الاجتهاد؛ لأنه فريضة لا يجوز تعطيلها بأي حالٍ من الأحوال، إضافة إلى أن المستجدات والنوازل التي أحاطت بالمجتمع الإسلامي حينذاك (رغم قلتها)، دفعتهم إلى خوض هذا المعترك، فعلى سبيل المثال اجتهد عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- وهو خليفة للمسلمين وعطل في عام الرمادة([1]) إقامة حد السرقة رغم وجود نص قرآني قطعي الثبوت والدلالة يُوجب إقامته، والدوافع التي قادت الخليفة الثاني إلى هذا الاجتهاد كثيرةٌ، ولكننا نكتفي بذكر هذه الكلمات التي أوردها الحافظ ابن كثير: «وقد روينا أن عمر عسَّ (تفقد) المدينة ذات ليلة عام الرمادة، فلم يجد أحدًا يضحك، ولا يتحدث الناس في منازلهم على العادة، ولم ير سائلًا يسأل، فسأل عن سبب ذلك، فقيل له: يا أمير المؤمنين، إن السؤَّال سألوا فلم يعطوا، فقطعوا السؤال، والناس في هم وضيق فهم لا يتحدثون ولا يضحكون».
والذي يجب أن يستوقفنا في هذه الرواية هو «نضج العقلية الإسلامية ورقيها إلى أبعد الحدود»؛ فلم يدفع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- إلى الاجتهاد وتعطيل العمل بحدِّ السرقة، عرائض رفعها الناس إليه يشكون فيها ضيق حالهم، أو تظاهرة خرجت في شوارع المدينة المنورة (عاصمة الخلافة حينذاك)، بل كان «اختفاء الابتسامة من على الوجوه» هو الدافع الذي حركه؛ لذلك لم ينتظر أن يخوض الناس معارك ليستجيب لهم فيجتهد ويجدد، بل سارع بنفسه في تطبيق فريضة شُرعت لجعل الدين صالحًا لكل زمان ومكان، وبمعنى آخر اجتهاد يُبقي الدين مصدرًا للحياة (حياة الأجساد والأرواح معًا)، وشتان الفارق بين الماضي والحاضر.
سارع خليفة المسلمين إلى الاجتهاد؛ لأنه لاحظ همًا وضيقًا عصفا بالمجتمع الإسلامي حينذاك، وشدة الجوع دفعت بعض الناس إلى السرقة، ومن غير المعقول أن تُقطع يدُ سرقت ليحيا صاحبها، وهذا ما اطمأن إليه قلب «عمر»، ودفعه إلى تعطيل نص قرآني قطعي الدلالة والثبوت، يقول الله تعالى فيه: «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ» (المائدة: 38)، وعلى مثل هذا نستطيع قياس اجتهاده -رضي الله عنه- في منع سهم المؤلفة قلوبهم، وإسقاط الجزية عن نصارى بني تغلب، وكذلك اجتهادات الفقهاء والعلماء والأئمة منذ عهد الصحابة وحتى القرن العاشر الهجري، وجميعها كانت مواكبة لمتطلبات العصر الذي عاش فيه هؤلاء السابقون، الذين لم يجتهدوا ليوجدوا حلولًا لمشكلات عصرنا الراهن، وإنما اجتهدوا للتغلب على ما ألمَّ بالناس في عصرهم من نوازل ومستجدات.
والحقيقة التي نحتاج إلى التأكيد عليها في هذا الموضع، هي أن فريضة الاجتهاد شُرعت بنص قرآني، وقول وإقرار نبوي، وطبقها الصحابة والتابعون عمليًّا، كما ذكرنا في المحور الثاني من هذه الدراسة، ولذا فإنه لم يبق أمام وضوح هذا التشريع وقوته أي مجال لإنكار هذه الفريضة، أو حتى قصرها على أزمنة بعينها، وفي هذا يقول الشيخ أمين الخولي (مايو 1895 - مارس 1966): «لم يبقَ بعد ذلك مقالٌ لقائلٍ ولا اعتراضٌ لمعترضٍ، ولم تعد فكرةُ التَّجديدِ بدعًا من الأمر يختلف الناس من حوله، فتخسر الحياة ضحايا من الأشخاص والأعراض والأوقات مما ينبغي أن تدخره لتفيد منه في ميادين نشاطها، ولا تُضيِّعُ الوقت في تلك المهاترات التي تكثُرُ وتسخُفُ حول كل محاولةٍ جادةٍ لدفع الحياة الدينية والاجتماعية إلى ما لابد منه من سيرٍ وتقدمٍ وتطورٍ ووفاءٍ بما يجدُّ دائمًا من حاجات الأفراد والجماعات»([2]).
كما لا يجوز لأهل أي عصرٍ تعطيل فريضة الاجتهاد مكتفين بما جادت به قرائح من مضى؛ لأنه لولا هذه الفريضة لما أصبح للأمة الإسلامية أي شأن يُذكر بين الأمم، ولولاها لعجز السابقون (الذين نفتخر بتراثهم) عن ترك هذا التراث الذي يدلُ دلالة قطعية على أننا كنا أمة مواكبة لركب الحضارة، إن لم نكن نتسيد ركب الأمم، وفي هذا المعنى يقول محمد الشوكاني (ت 1250هـ): «لا يجوز خلو الزمان من مجتهد قائم بحجج الله يبين للناس ما نزل إليهم، بل لابد أن يكون في كل عصر مَن يقوم به»([3])، وإذا قصر في تحصيله أهل عصر فإن «أهل ذلك العصر قد أثموا بتركه، وأشرفوا على الهلاك، وتكون الأمة بكاملها آثمة لتركه»([4]).
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذا نحن نصرُّ فيما مضى من هذه الدراسة على الاستدلال باجتهاد الصحابة ومن جاء بعدهم وقوفًا عند القرن العاشر الهجري دون أن نتقدم عن هذه القرون العشرة قيد أنملة؟ إن الإجابة ببساطة شديدة تتمثل في أننا أُرغمنا على هذا التخصيص؛ لأن العلماء في القرون الخمسة الأخيرة هم من رفعوا راية «التقليد»، وعطلوا هذه الفريضة الإسلامية المحركة لكل أبعاد الحياة، وأعلنوا بكل أريحية أن باب الاجتهاد أغلق بعد انقضاء القرن العاشر الهجري، واتخذوا من آراء الأئمة السابقين حلولًا لمستجدات عصرهم، غير عابئين بأن تلك الآراء استحدثت للقضاء على مشكلات أمة خلت، تختلف في مكوناتها الجغرافية والسكانية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية عن مكونات الأمة فيما تلى تلك القرون العشرة.
الواقع المؤسف يؤكد أن العلماء المعاصرين رفعوا منذ 500 عام مضت، راية «التقليد»، ولم يكتفوا بهذا، بل حاربوا بكل قوةٍ أي دعوة تنادي بالتجديد، متعللين بأن السابقين تركوا ما يكفي لحلِّ أي مستجد يطرأ على حياة من يأتي بعدهم، وبالتالي أصبح الاجتهاد أمام هذه الجمود هو «الفريضة الغائبة»، ولعل هذا ما يؤكده الدكتور محمود حمدي زقزوق، رئيس مركز الحوار، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بقوله: «إنَّ الاجتهاد في عصرنا الحاضر هو الفريضةُ الغائبةُ، وممارسة الاجتهاد أصبحت فرضَ عينٍ على كلِّ من لديه المؤهلات لذلك»([5]).
ويصف «الصنعاني»، هؤلاء الرافعين لراية التقليد، الرافضين لأي تجديد، بقوله: «هذا كله هوس من هوساتهم لم يأتوا بدليل عليه، ولا يعبأ بكلامهم، وإنما هم الذين حكم الحديث أنهم أفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا»([6])، و«من حصر فضل الله على بعض خلقه، وقصر فهم هذه الشريعة على ما تقدم عصره، فقد تجرأ على الله عز وجل، ثم على شريعته الموضوعة لكل عباده»([7])، و«المجتهد المخطئ أفضل عند الله تعالى من المقلد المصيب؛ لأن الله تعالى ذم التقليد جملة، فالمقلد عاصٍ، والمجتهد مأجور»([8]).
وقد أكد الإمام أبو حامد الغزالي (منذ أكثر من تسعة قرون مضت) أن من ترك التجديد، واكتفى بالتقليد، فقد هلك هلاكًا مطلقًا، وذلك حين قال: «فاعْلَمْ يا أخِي أنَّك متَى كُنتَ ذاهِبًا إلى تَعرُّفِ الحَقِّ بالرِّجالِ مِنْ غَيرِ أن تَتَّكِلَ على بَصِيرَتِكَ؛ فقد ضَلَّ سَعْيُكَ؛ فإنَّ العالِمَ مِنَ الرِّجالِ إنَّما هو كالشَّمسِ أو كالسِّراجِ يُعطِي الضَّوْءَ، ثم انظُرْ ببَصرِكَ، فإن كُنتَ أَعمَى فما يُغنِي عنك السِّراجُ والشَّمسُ، فمن عَوَّلَ على التَّقلِيدِ هَلَكَ هَلاكًا مُطلقًا»([9]).
ويقول الدكتور محمود حمدي زقزوق: «والملاحظ أنه حتى يومنا هذا نجد فقهاءَنا حين يبحثون عن حلًّ شرعيًّ لمشكلةٍ جديدةٍ فإنهم يبحثون عن حلٍّ لها لدى بعض المذاهب الفقهية القديمة، وفي بطون الكتب التي أُلف الكثير منها في عصور التراجع الحضاري للأمة الإسلامية… فهل يُعقَلُ أن تكون الحلول التي توصَّل إليها الفقهاء السابقون -مع احترامنا لاجتهاداتهم التي كانت مناسبة لعصورهم- هي نفس الحلول لمشكلاتنا المعاصرة؟... إن الأمر الذي لا شك فيه أنَّ الفقهاء السابقين -الذين أَثْرَوُا الحياة الفقهية منذ قرونٍ طويلةٍ- لو قُدر لهم أن يُبْعَثوا من جديدٍ ويروا ما طرأَ على الحياةِ والأحياءِ في أزماننا من تطوراتٍ غيرِ مسبوقةٍ لتغيَّرتْ بالقطعِ نظرتُهم للأمورِ، ولكانت لهم وجهاتُ نظرٍ متجددةٍ أكثر تطورًا وأكثر فهمًا لمستجدات العصر من كثير مِن فقهائنا المُعاصرين»([10]).
ومما سبق يتضح لنا، أن اجتهاد المعاصرين كان «تقليدًا» لا «تجديدًا»، بل إنه تعدى حد التقليد كما ذكرنا إلى شن حرب ضروس ضد أي عالمٍ يقوم بواجبه ويجتهد بغية تجديد الفكر والخطاب الديني، وإذا نظرنا إلى القرن الماضي كأنموذج؛ فإن ما لاقاه الإمام محمد عبده، وأستاذه رفاعة رافع الطهطاوي، والشيخين عبدالمتعال الصعيدي، وعلي عبدالرازق، وغيرهم كثير، لخير دليل على فرض أصحاب العقلية الرجعية منهجهم التقليدي (الكارثي)، ووقوفهم حجر عثرة أمام أي دعوات للتجديد، بل ووصمهم أصحاب هذه الدعوات بـ«المبتدعين، والزنادقة» أحيانًا، وتجريدهم من رتبهم العلمية أحيانًا أخرى.
ففي منتصف القرن التاسع عشر نادى الإمام محمد عبده بالإصلاح الديني، وضرورة تجديد الفكر الإسلامي، والعمل على إصلاح المؤسسات الإسلامية كالأزهر والأوقاف والمحاكم الشرعية، وكانت تلك الدعوة الإصلاحية غريبة على مجتمع غط في سبات عميق لقرون طويلة، ولذلك تسببت في نفيه وتشريده خارج مصر أولًا، ثم بعد عودته إلى الوطن وتقلده منصب الإفتاء فإن أصحاب العقلية الرجعية لم يتركوه، وحاكوا المؤامرات والدسائس ضده، وشنوا هجومًا قاسيًا عليه في الصحف لتحقيره والنيل منه، ولجأ خصومه إلى العديد من الطرق الرخيصة والأساليب المبتذلة لتجريحه وتشويه صورته أمام العامة؛ حتى اضطر إلى الاستقالة من كل مناصبه عام 1905م.
وحين سعى الشيخ الجليل علي عبدالرازق، إلى إخراج المسلمين من حالة التخبط والتيه التي أصابتهم عقب إلغاء القائد التركي «كمال أتاتورك» عام 1924 الخلافة العثمانية، وذلك بتأليفه كتاب «الإسلام وأصول الحكم» (صدر عام 1925)، وتأكيده أن الخلافة ليست أصلًا من أصول الحكم في الإسلام، وأنها مجرد اجتهاد ارتبط بحدث محدد، وهو وفاة الرسول -صلى الله عليه وسلم- فكانت ضرورية حينذاك للحفاظ على الإسلام والدولة، ولكنها لم تكن فرضًا، وأوضح أن مفهوم القضاء منفصل عن الشريعة، معتبرًا إياه ضمن المنظومة السياسية وليست الدينية، وغير ذلك من الحقائق التي يُقرها الدين الإسلامي، هبت تجاهه عاصفة من الهجوم الشرس، واتهمته هيئة كبار علماء الأزهر بـ«الضلال»، ورأت أن الكتاب خرج عن حدِّ المعتقدات، وعليه حوكم الشيخ وفُصل من منصبه كقاضٍ شرعي، وطُرد من زمرة العلماء، وجُرد من رتبته العلمية (شهادة العالمية).
وبالتأكيد؛ فإن الذين حقروا من اجتهاد الإمام محمد عبده، وجردوا الشيخ علي عبدالرازق من رتبته العلمية، لم تعي قلوبهم قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد»، لذلك نجدهم رفضوا أن يحمدوا للرجلين اجتهادهما، ثم ينظرون في صوابه من عدمه؛ فإن كان صائبًا فبها ونعم، وإن كان العكس فلهما أجر، ولكنهم حاربوا «التجديد» وعضوا بالنواجذ على «التقليد»، و«هذه المواقفُ المُتحجرةُ تسيرُ في اتجاهٍ مُضادٍّ لسنَّةِ الحياةِ وطبيعةِ الأشياءِ؛ فركْبُ الحياة يُواصلُ السيرَ بلا انقطاعٍ وعجلةُ الزمنِ لا تتوقفُ عن الدَّوَرانِ، ولكنَّ عقولَ كثيرٍ من القائمين على أمرِ الدِّينِ لم تَعُدْ قادرةً على مُسايرةِ الزمنِ ولا مُؤهِّلةً لفهمِ تطوراتِ العصرِ، وأصبحتْ أصواتُ المُنادين بالتَّجديدِ صرخة في وادٍ أو نفخةٍ في رماد»([11]).
ولا تقف كارثية «التقليد»، عند حد إلغاء العقل، وإصابة الفكر الإسلامي بالجمود؛ بل تتعدى هذا إلى حد تقديس الفقهاء والأئمة السابقين، واعتبار نتاج اجتهاداتهم (المحمود في زمانه) هو الدين، ورفع هذه الأعمال الاجتهادية إلى مرتبة مساوية للقرآن والسنة، ووصفها وحدها بـ«الحق»، ووصم أي رأي مستحدث يخرج عن عباءتها بـ«الباطل»، وذلك بالرغم من أن المجددين الأوائل أنفسهم رفضوا رفضًا مطلقًا اعتبار ما جادت به قريحتهم هو «الحق الذي لا مراء فيه»، و«الأمرُ الَّذي لاشكَّ فيه أنَّ آراءَ الفقهاءِ السَّابقينَ كانت –وستظلُّ- مُجرَّدَ اجتهاداتٍ تُخْطئُ وتُصيبُ، ولم يَدَّعِ مؤسِّسو المذاهبِ الفقهيَّةِ أبدًا أنَّ ما يقولونه هو الحقُّ المطلقُ؛ فقد قِيلَ للإمام أبي حنيفةَ النعمان: إنَّ هذا الَّذي تَفتي به هو الحقُّ الَّذي لا مِراءَ فيه، فردَّ قائلًا: لا أدري، لعلَّه الباطلُ الَّذي لا مِراءَ فيه، ومِن المأثورِ أيضًا عن الإمامِ محمد بن إدريس الشَّافعيِّ، قوله: رَأْيُنا صوابٌ يحتملُ الخطأَ، ورأيُ غيرنا خطأٌ يحتملُ الصَّواب»([12]).
وقد عاب الإمام محمد عبده (منذ أكثر من قرنٍ من الزمان)، على الفقهاء المعاصرين تمسكهم الحرفيَّ بما جاء في كتب السابقين، على الرغم من اختلاف ظروف الزمان والمكان، وذلك حين قال: «لقد جعل الفقهاء كتبهم هذه -على علاتها- أساس الدين، ولم يخجلوا من قولهم: إنه يجب العملُ بما فيها، وإن عارض الكتاب والسنة؛ فانصرفت الأذهان عن القرآن والحديث، وانحصرت أفكارهم في كتب الفقهاء على ما فيها من الاختلاف في الآراءِ والرَّكاكةِ»([13]).

المحور السادس: نماذج من تقليد المعاصرين
سنذكر في هذا الموضع 3 نماذج طلب المجتمع الإسلامي فيها من العلماء المعاصرين أن يجتهدوا ليضعوا حلولًا للمستجدات التي نزلت بهم، وللأسف وكالعادة قلدوا واعتمدوا على آراء السابقين ولم يجددوا:
(1) ختان الإناث:
في أواخر القرن الماضي لاذ المجتمع الإسلامي برجال الدين، ليفتوهم في قضية «خِتانِ الإناث»، خاصة بعد فقدان عدد من الفتيات حياتهن بسبب هذا الأمر، وبعد انتظار خرجت الفتوى الرسمية من شيخ الأزهر الراحل الشيخ جاد الحق علي جاد الحق (ت 1996م) والتي قال فيها: «اتّفقت كلمة فقهاء المذاهب على أن الختان للرجال والنساء من فطرة الإسلام وشعائره، وأنه أمر محمود، ولم ينقل عن أحد من فقهاء المسلمين فيما طالعنا من كتبهم التي بين أيدينا قول بمنع الختان للرجال أو النساء، أو عدم جوازه أو إضراره بالأنثى».
وأخطر ما في هذه الفتوى المعتمدة بالكلية على ما ورد في كتب السابقين دون أي سعي إلى التجديد، هو قول الشيخ الراحل: «وفي الختام -وفي شأن الختان عامّة للذكر والأنثى- نذكّر المسلمين بما جاء في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة: لو اجتمع أهل بلد على ترك الختان قاتلهم الإمام (أي ولي الأمر)؛ لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه، إذ مقتضى هذا لزوم الختان للذكر والأنثى، وأنه مشروع في الإسلام».
وكما نرى من نص الفتوى، فقد اعتبر الشيخ جاد الحق، «خِتانِ الإناث» من شعائر الإسلام وخصائصه، وأدلته فيما ذهب إليه هي أقوال السابقين، ويجدر بنا هنا أن ننقل ما يقوله الدكتور محمود حمدي زقزوق، حول هذه الواقعة على وجه الخصوص: «دار البحث حول خِتانِ الإناث الذي هو مُجرَّد عادة وليس عبادةً، وأنَّ ما ورد بشأنه من أحاديثَ كلُّها ضعيفة لا تُقيم حجة ولا يُعتدُّ بها، ولكنَّ أحد الشُّيوخ الأَجِلاء عندما بحث هذه القضيَّةَ لجأ إلى البحث في ذلك عمَّا قاله السَّابقون وانتهى في ختام بحثه إلى نتيجة مُروِّعة مُرددًا في هذا الصَّدد ما ذهب إليه بعضُ أصحاب المذاهب الفقهيَّة من رأي يقول: لو اتَّفق أهلُ بلد على عدم خِتان الإناث فعلى الإمام أن يُقاتلَهم على ذلك»([14]).
ويؤكد الدكتور زقزوق أنه تحدث مع الشيخ الجليل، حول هذا الأمر؛ إلا أن الرد كان صادمًا، ولنقرأ القصة كاملةً: «وقد تحدَّثتُ مع شيخنا الجليل -رحمه الله وطيَّب ثَراه- عن ضرورةِ الاجتهادِ وعدمِ الوقوفِ عندَ ما قاله السَّابقون فكان ردُّه: عندَما نكونُ مِثلَهم في علمهم يَحقُّ لنا الاجتهادُ، وهذا أمرٌ غيرُ قائِمٍ في عصرنا»([15]).
(3) تولي المرأة القضاء
والنموذج الثاني الذي نورده هنا، والذي يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك، أن «التقليد» تجذر في نفوس أكثرية فقهائنا المعاصرين، وأنهم يؤثرون في كلِّ قضية مستجدة اللجوء إلى آراء السابقين دون أي محاولة للاجتهاد، قضية اشتغال المرأة بالقضاء، وبالتأكيد كانت الفتوى صادمة كغيرها؛ لأنها ببساطة شديدة لم تكن نتاج اجتهاد، بل كانت نقلًا عن الآخرين.
وفي هذا يقول الدكتور محمود حمدي زقزوق: «ومن الأمثلة على شيوعِ التَّقليدِ غيرِ المقبولِ لدى الكثيرين من فقهائِنا، إلى الحدِّ الَّذي يصلُ إلى إلغاءِ العقولِ تمامًا وإلغاءِ وظيفِتها في التَّفكيرِ؛ بحثَهم في الآونةِ الأخيرةِ قضيَّةَ اشتغالِ المرأةِ بالقضاءِ، وبدلًا من أن ينظروا أولًا في وضعِ المرأةِ في المجتمعِ المُعاصر ومدى ما وصَلَتْ إليه من ثقافةٍ راقيَةٍ وعقليَّةٍ واسعةٍ وأُفُقٍ رَحْبٍ وتخصُّصٍ دقيقٍ في جميع مجالات العلوم والفنون، بدلًا من ذلك كله لجأ فقهاؤنا الأجِلَّاءِ إلى البحثِ في بطونِ الكتبِ عمَّا قاله أصحابُ المذاهبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ في هذه القضيَّةِ، وتوصَّلوا إلى أنَّ مذاهبَ الشافعيَّةِ والمالكيَّةِ والحنبليَّةِ لا يُقرِّونَ تولِّيَ المرأة لأمورِ القضاءَ بجميعِ درجاتِه، أما بعضُ الحنفيَّة فقد أجازوا أن تتولَّى المرأةُ القضاءَ في الأحوالِ الشَّخصيَّةِ والمدنيَّةِ، ولكنَّها ليستْ مُؤهَّلة لتولِّي القضاءِ في الجِناياتِ، على الرِّغمِ من عدم وجودِ نصٍّ قاطعٍ يُعتَمدُ عليه يَحرِمُ المرأةَ من هذا الحقِّ»([16]).
(3) المساواة في الميراث
وآخر القضايا التي ثار حولها جدل (وليس آخرها بالتأكيد لأن المستجدات سنة حياتية)، هي المطالبة بمساواة المرأة بالرجل في الميراث؟ وقد دار الجدل حول هذا الأمر عقب إقرار تونس قانون يساوي بين الجنسين في الميراث، وهو ما جعل الكثير من الأصوات تخرج متسائلة: ولماذا لا يعمم هذا الأمر في كلِّ البلدان الإسلامية؟ خاصة أن العلة من التفرقة هي بقاء النساء في بيوتهن وتولي الرجال النفقة عليهن، والآن نحن نعيش في عصر اقتحمت السيدات فيه سوق العمل، وأثبتن قدرتهن على الإنفاق على أسرهن، إذًا فقد زالت العلة، فما الداعي لبقاء الحكم؟ هكذا طرح الراغبون في المساواة رؤيتهم.
ومن جانبهم رفض رجال الدين هذه الأطروحات رفضًا قاطعًا، مؤكدين أن «النصوص إذا كانت قطعية الثبوت والدلالة معًا فإنها لا تحتمل الاجتهاد، مثل آيات المواريث الواردة في القرآن الكريم، والنصوص الصريحة المنظمة لبعض أحكام الأسرة؛ فإنها أحكام ثابتة بنصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة بلا ريب، فلا مجال فيها لإعمال الاجتهاد»، والسؤال الذي يطرح نفسه أمام هذا الرأي التقليدي: إذا كانت النصوص قطعية الثبوت والدلالة لا مجال فيها لإعمال الاجتهاد، فكيف منع صحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سهم المؤلفة قلوبهم، وأسقطوا ضريبة الجزية، وحدِّ السرقة، بالرغم من أن جميع هذه الأحكام مُستنبطة من آيات قرآنية قطعية الثبوت والدلالة معًا؟
والسؤال الآخر وهو الأكثر أهمية: هل يحسم الفقهاء الجدل حول «أحكام الميراث» باجتهاد يقتنع معه الناس بآرائهم (أيًّا كانت هي) لا بـ«تقليد» يثير الجدل أكثر من القضية نفسها؟ أم أن لقوة القانون المدعوم بإرادة مجتمعية (تونس نموذجًا) رأي آخر؟
وعقب عرضنا لهذه النماذج التي تمسَّك فيها المعاصرون بالتقليد، ووقوفوا حجر عثرة أمام التجديد، بقي أمامنا استعراض عواقب تعطيل الاجتهاد، والكوارث التي تكبدها المجتمع جراء جمود الفكر الإسلامي، وهذا ما نسرده في الجزء الرابع والأخير من هذه الدراسة.
ثَبْتُ الْمَصَادِرِ وَالْمَرَاجِعِ:
[1] - عام الرمادة: كان في خلافة عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- في آخر سنة 17 هجرية إلى أول سنة 18 هجرية، ووقعت فيه مجاعة عظيمة، فمنع المطر وجفت الأرض وهلكت الماشية، وبقي المسلمون على هذا الحال 9 أشهر، وقد سمي بالرمادة نظرًا لأن الأرض أصبحت سوداء تُشبه الرماد.
[2] - «المجددون في الإسلام»، للشيخ أمين الخولي.
[3] - «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول»، لـ«محمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكاني اليمني»، ص 253.
[4] - «المستصفى»، للإمام أبي حامد الغزالي 2/12، و«الإحكام في أصول الأحكام» 3/158، لـ«أبي الحسن علي بن سالم الثعلبي الآمدي» (ت 631هـ).
[5] - «الفكر الديني وقضايا العصر»، للدكتور محمود حمدي زقزوق، ص 36.
[6] - محمد بن إسماعيل الكحلاني الصنعاني، المعروف بالأمير (ت 1182هـ).
[7] - «إرشاد الفحول»، للشوكاني، ص 224.
[8] - «المحلى»، لابن حزم الأندلسي، المجلد الأول، ص 88.
[9] - «معراج السالكين»، للإمام أبي حامد الغزالي ص 298/ 299.
[10] - «الفكر الديني وقضايا العصر»، للدكتور محمود حمدي زقزوق، ص 32/ 33.
[11] - «الفكر الديني وقضايا العصر»، للدكتور محمود حمدي زقزوق، الفصل الأول: الفكر الديني والحقائق الغائبة، ص 15.
[12] - المرجع السابق، ص 34.
[13] - «الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده»، تحقيق د. محمد عمارة جـ 3 ص 195. بيروت 1980.
[14] - «الفكر الديني وقضايا العصر»، للدكتور محمود حمدي زقزوق، الفصل الأول: الفكر الديني والحقائق الغائبة، ص 35.
[15] - المرجع السابق.
[16] - المرجع السابق.