اجتهاد القدماء والمعاصرين.. فرضية التجديد وإشكالية التقليد (1 - 4)
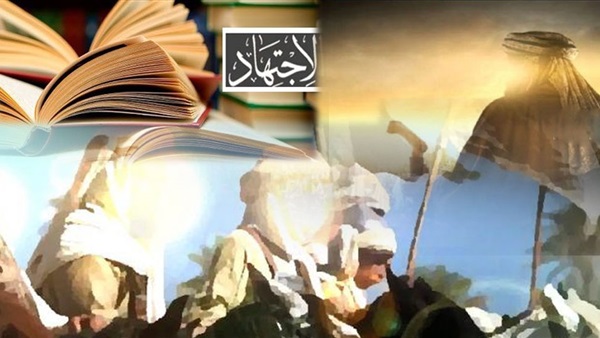
◄ تمهيد

جميع الصحابة (مُجدِّد، أو مُجدَّد له) كانوا يؤمنون بأن هذا الدين جاء ليكون محركًا للحياة بكل أبعادها، وأدركوا -عن معرفة راسخة وفهم عميق- أنه دين علم ومعرفة وأخلاق وحضارة؛ فضلًا على كونه عقيدةً وشريعةً؛ لذا كانت عقولهم تعي جيدًا أن الأصل في التشريع الإسلامي هو إسعاد الناس، ومواكبة ظروفهم المجتمعية ومقتضيات العصر الذي يعيشون فيه، وأن النصوص الدينية لم تكن يومًا (ولن تكون) مجرد حروفٍ جامدةٍ تحويها الصدور وتحفظها الأوراق، لتبقى كالأحجار يثقلُ بحملها كاهل كل المؤمنين بها.
المسلمون منذ عهد الصحابة ومن جاء بعدهم من التابعين، آمنوا أن في الاجتهاد إثراءً للفكر الإسلامي، وأدركوا أنه سنةٌ إلهية وفريضة دينية وضرورةٌ حياتية؛ لذلك اجتهدوا وقادهم اجتهادهم إلى منع سهم «المؤلفة قلوبهم»، وتعطيل العمل بـ«حد السرقة»، وإلغاء أحكام الرق، وإسقاط الجزية عن أهل الكتاب، وغير ذلك من المسائل والقضايا التي كانت تشغل عصرهم، ولم يمنعهم من إعمال العقل المستند إلى إيمان راسخ لا يتزعزع؛ كون التشريعات التي عطلوا العمل بها مستنبطة من نصوص قرآنية قطعية الثبوت والدلالة، وكان دافعهم في هذا «مصلحة الناس، ومواكبة مقتضيات عصرهم، وإبقاءَ الدين صالحًا لكل زمان ومكان»، دون تفريط في نصوص مقدسةٍ اصطفاهم الله ليكونوا خير معين لنبيه -صلى الله عليه وسلم- في نشرها.
ثم مضى عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم، وتوالت السنوات تتبعها القرون، وجاء الدور على العلماء المعاصرين ليؤدوا أمانة الاجتهاد، ومن ثم الإدلاء بدلوهم في مجال تجديد الخطاب الديني، خاصة أن القضايا المعاصرة باتت تحاصر المجتمعات الإسلامية من كل حدب وصوب، وعجت رؤوس الشعوب بالعشرات (إن لم يكن المئات) من الأسئلة، والتي كان آخرها -كنموذج- الجدال الذي مازال مستمرًّا حول مطالبة البعض بإعادة النظر في أحكام المواريث، وضرورة مساواة المرأة بالرجل في الحقوق المتعلقة بهذا الجانب، خاصة أن المطالبين بالمساواة يقولون: إن العلة التي سن من أجلها هذا التفاوت في القسمة قد انتهت، والضرورة الحياتية الراهنة تقتضي تحقيق مساواة حقيقية بين الجنسين، وغيرها من قضايا وأسئلة كثيرة شُغل بها الناس، ويحتاجون إلى من يجيبهم عليها؛ جوابًا تقتنع به العقول، وتطمئن إليه القلوب، أو كما يقول علماء المنطق «جوابًا جامعًا مانعًا».
وفي كل قضية من القضايا المعاصرة، كان علماءُ الإسلام المعاصرون يهرعون إلى «تقليد القدماء»، فما أجازه السلف أقره الخلف، والعكس صحيح، وانتشرت بين المسلمين مقولاتٌ من قبيل «ليس في الإمكانِ أبدعُ ممَّا كانَ»، «ولم يَتركِ الأوَّلُ للآخِر شيئًا»؛ وهو ما يُشير إليه الدكتور محمود حمدي زقزوق، رئيس مركز الحوار، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بقوله: «التيار الأعظم من علماء المسلمين على مرِّ العصور وقف عقبة في طريق أي تجديد، ناهيك عن أي اجتهاد، ومن هنا تجمّد الفكر الديني، وتجمّد الاجتهاد». ([1])
المقارنة بين إيمان المسلمين الأوائل بالاجتهاد قلبًا وقالبًا، وتطبيقهم له عمليًّا على أرض الواقع، وتعطيلهم العمل بأحكام مستنبطة من آيات قرآنية قطعية الثبوت والدلالة، ووقوف علماء الإسلام المعاصرين في اجتهادهم عند حدِّ «التقليد»، ورفضهم المطلق الاقتراب من أي تشريع مستنبط من نص قرآني، هو موضوع هذه الدراسة التي تحمل عنوان: «اجتهاد القدماء والمعاصرين.. فرضية التجديد وإشكالية التقليد»، وتتضمن 7 محاور هي:
المحور الأول: تعريف الاجتهاد وشروطه
المحور الثاني: لماذا سارع القدماء إلى الاجتهاد؟
المحور الثالث: نماذج من اجتهاد المسلمين الأوائل
المحور الرابع: ثمرة اجتهاد السابقين
المحور الخامس: اجتهاد المعاصرين.. تجديد أم تقليد؟
المحور السادس: نماذج من تقليد المعاصرين
المحور السابع: عواقب التقليد وتعطيل الاجتهاد
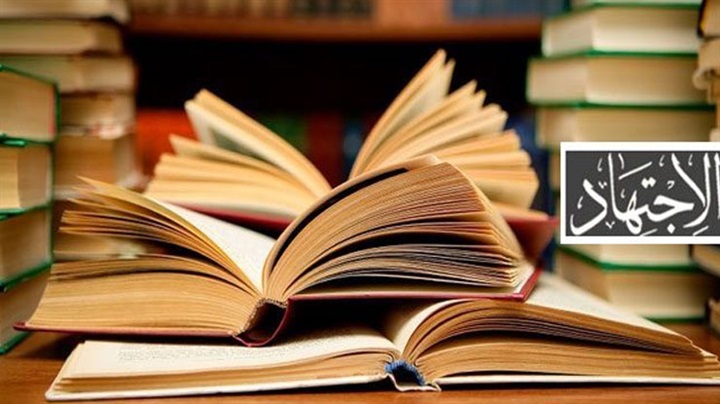
المحور الأول: تعريف الاجتهاد وشروطه
يُعرف الاجتهاد، بأنه «بذلُ المُجتَهِدِ وسْعَهُ في طلبِ العِلْمِ بأحْكامِ الشَّرِيعَةِ»([2])، أو «بذل كل ما في الوسع لاستنباط الأحكام الشرعية للمسائل الرئيسية والفرعية التي تظهر في حياة الناس، أو إعادة النظر في أحكام بعض المسائل الفقهية؛ بحيث تصبح موافقة ومتناسبة مع الزمان والمكان والأحوال»، وفي رأينا، نقول: «إنه إيجاد حلول لكل القضايا المعاصرة، تواكب التَّغيرات التي تطرأ على حياة الناس في مختلف الأزمنة والأمكنة، دون تفريط يجعلهم ينفضون أيديهم من تعاليم السماء، أو إفراط يهوي بهم إلى براثن التشدد والتطرف».
وهو بهذا يختلف عن الفتوى، التي يقتصر دور القائمين عليها على التقليد، أي مجرد الإخبار عن حكم الشرع في أي مسألة نقلًا عن السابقين؛ لذا فإن كلَّ مجتهدٍ مُفْتٍ لأنه «مجدد»، وليس كلُّ مُفْتٍ مجتهدًا لأنه «مقلد».
والاجتهاد، على قسمين؛ الأول: اجتهاد جزئي أو «مُقيَّد»، وهو موقوف على أي شخص بلغ المرتبة العُليا في المعرفة بفرع من فروع العلوم الشرعية، أو حتى في باب من الأبواب الفقهية، مثل من برع في الإلمام بأحكام الحج فقط، أو المعاملات المالية في الإسلام، أو غيرهما، وهذا الشخص يحق له التجديد في الفرع الذي تخصص فيه وأحاط بكل جوانبه، وما دونه من علوم فهو فيها «مقلد»، وليس «مجدد».
أما القسم الثاني من الاجتهاد؛ فهو اجتهاد كلي، أو «مُطلق»، وهو موقوف على أي شخص بلغ المرتبة العُليا في المعرفة بشتى أصناف العلوم الشرعية، وهذا «الجامع» يحق له التجديد في كلِّ القضايا الإسلامية، وأكثرية علماء الدين الإسلامي المعاصرين (إن وُجِد بينهم مجتهد)؛ فاجتهاده جزئي وليس مطلقًا، وفي هذا يقول العالم السوري الراحل الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي: «يوجد الآن في عصرنا مجتهد في الجزئيات والأحكام، وأعتقد أنه لا يوجد في هذا العصر من يُسمى مجتهدًا مطلقًا»([3]).
وللاجتهاد شروط؛ يجب أن تتوافر في كل من أراد دخول هذا المعترك، وهي واجبة التحقق، وبفقدانها لا يلتفت لأقوال المجتهد، ومن أهم هذه الشروط: صحة عقيدة المجتهد، ومعرفته بكتاب الله فقهًا ومعنًى وحكمًا، وملازمته للسنة، والإلمام بجملة من العلوم (عدّها البعض 19 علمًا) منها: علوم القرآن، وعلى رأسها التفسير، وأسباب النزول، وآيات الأحكام، الناسخ منها والمنسوخ، والمحكم والمتشابه، والمجمل والمفصل، والعام والخاص، ومعرفة سيرة النبي -صلى الله عليه وسلم- لأنها تطبيق عملي للقرآن، والدراية التامة بالحديث وأصوله، والفقه وقواعده وأصوله، وأحوال البشر وعادات الناس، ومعاقد الإجماع، ووجوه القياس، وأن يكون مجيدًا للغة العربية وعلومها من نحو وتصريف واشتقاق وغيرها، وأن يكون محصلًا لعلوم البلاغة من معانٍ وبيانٍ وبديعٍ، وأن يكون عالمًا بالأدب قديمه وحديثه، أو ما يُسمى «ديوان العرب»([4]).
والاجتهاد، أصل من أصول الشريعة الإسلامية، وضرورة دينيَّةٌ وشرعيَّةٌ وحياتية، وهو يندرج في حكمين؛ الأول: يكون فرض كفاية إذا قام به العلماء والمصلحون في كلِّ زمان ومكان، ويسقط عن باقي الأمة، والثاني: يصبح فرض عينٍ على كل مسلم يمتلك مؤهلاته إذا انعدم المجتهدون، أو قَصّر المعنيون بهذا الشأن في القيام بدورهم، ولا يجوز بأي حالٍ من الأحوال تعطيله أو حتى التباطؤ عن القيام به متى دعت الضرورة إليه؛ وذلك لأن «الشَّريعة صالحة لكُلِّ زمانٍ ومكانٍ، ونُصوص الكِتابِ والسُّنَّةِ محدودة، وأحوال النَّاسِ ووسائِلهم إلى مَقاصِدِهم مُتجدِّدة وغيرُ محدودةٍ، ولا يُمكِنُ أن تَفِيَ النُّصوصُ المحدودةُ بأحكامِ الحوادثِ -المتجدِّدةِ غيرِ المحدودةِ- إلَّا بالاجتهادِ»([5]).
والاجتهاد إما أن يكون «فرديًّا»، أو«جماعيًّا»، والفيصل في هذا، وجود المجتهد الجامع، من عدمه، واجتهاد الصحابة -رضي الله عنهم- والتابعين كان «اجتهادًا فرديًّا»؛ لأنهم ملكوا مؤهلاته، والاجتهاد في عصرنا الراهن جماعي؛ لعدم وجود «مجتهد جامع»، وللتغلب على هذه الإشكالية أنشئت «المجامع الفقهية» (تضم في عضويتها مجموعة من العلماء كل منهم تخصص في علم معين، وبلغ رتبة المجتهد فيه، وتتلاقى جهودهم جميعًا لتشكل جمعيتهم «مجتهدًا جامعًا»).

المحور الثاني: لماذا سارع القدماء إلى الاجتهاد؟
متى بدأ الرعيل الأول من المسلمين التطبيق العملي لـ«فريضة الاجتهاد»؟ هل منذ سنوات الإسلام الأولى وهم بين يدي رسول الله، أو بعد انقطاع الوحي بوفاته صلى الله عليه وسلم؟
إن الإجابة عن هذين السؤالين بمثابة الرأس من جسد هذه الدراسة؛ لأنها ستقودنا إلى نتيجة حتمية لا جدالَ فيها؛ فإما أن يكون الاجتهاد شُرِعَ بنص قرآني، وقول وإقرار نبوى، وتطبيق عملي من الصحابة، ومن ثَمَّ يُصبح فرضًا على باقي الأمة، ومبدأً مستمرًّا على مدى الأزمان، وليس خاصًّا بفترة زمنية معينة، ومن ثم يكون الفقهاء في كل العصور مطالبين بالقيام به دون توقفٍ، ولا يجوز لهم أن يعطلوه بأي حال من الأحوال، ومن يتوقف منهم عن القيام به يكون بمثابة من يُغلق باب الرحمة الذي فتحه الله على مصراعيه لهذه الأمة، ويُعد فعله هذا حجرًا على العقول، ومصادرة على حقها في الفهم والفكر.
وإما أن يكون الاجتهاد، سُنّ نزولًا على رأي فردي ظهر فيما تلى العهد النبوي، وسنوات الخلافة الراشدة، ولم تقره الأمة في أي زمان ومكان، ومن ثًم ينتقل حكمه من «الفرض» إلى «المستحب»، وبالتالي يكون المسلمون مخيرين بين القيام به مواكبةً لتطورات العصر الذي يعيشون فيه، وتركه وإلغاء عقولهم، نزولًا على أقوال من يفرضون «التقليد» ويرفضون «التجديد».
والقراءة المتأنية في سيرة النبي -صلى الله عليه وسلم-، والخلفاء الراشدين، والحقب الأولى من التاريخ الإسلامي (القرون الثلاثة الهجرية الأولى تحديدًا)([6])، تؤكد لنا أن المسلمين الأوائل كانوا مؤمنين بـ«الاجتهاد»، وقد تجذّر هذا الإيمان في قلوبهم إلى أبعد الحدود، حتى إنهم عدُّوه فريضةً متلازمةً لا تنفك بأي حال من الأحوال عن باقي التشريعات والأحكام الإسلامية المفروضة.
وقد طبق الصحابة -رضي الله عنهم- الاجتهاد، بطريقة عملية، منذ سنوات الإسلام الأولى، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين أظهرهم، وأطلقوا العنان لعقولهم (المستندة إلى إيمان راسخ لا يتزعزع)؛ لتدلي بدلوها الفكري في كل شأن يتعلق بأمور الدين والدنيا.
والصحابة -رضى الله عنهم- سارعوا إلى الاجتهاد؛ لإيمانهم أن في هذه المسارعة تطبيق لفريضة إسلامية، وإحياءُ لأصل من أصول الشريعة، نصّ عليه القرآن الكريم في أكثر من موضع، ومن ذلك قول الله تعالى: «إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ» (النساء: 105)، وهذه الآية تتضمن إقرار الاجتهاد عن طريق القياس، وقوله جل وعلا: «وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ» (الجاثية: 13)، و«إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ» (النحل: 12)، و«وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ» (القمر: 22)، و«كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ» (ص: 29)، و«أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (82) وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِه وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ َلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا» (النساء: 82، 83)، وهناك العديد من الآيات القرآنية التي تدل على أن الاجتهاد فرض، وتؤكد على وجوب إعمال الفكر والعقل.
وقد حثَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- أصحابه على الاجتهاد، وإذا أردنا تعبيرًا أكثر دقة، نقول: «إنه دفعهم إليه دفعًا»، وعلمهم بطريق تدريجي (كما هو الغالب الأعم في التشريعات الإسلامية)، كيف يصل المجتهد إلى غايته؟ ومن ذلك ما رواه الحارث بن عمرو، عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ بن جبل: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذًا إلى اليمن قال: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله، قال فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: أقضي بما قضى به رسول الله، قال: فإن لم تجد فيما قضى به رسول الله؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو. فضرب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم صدره، وقال: الحمد لله الذي وفّق رسول رسول الله لما يُرضي الله ورسوله([7]).
ويؤكد الحديث السابق -بما لا يدع مجالًا للشك- أن الصحابة قد اجتهدوا في الكثير من الأحكام في العهد النبوي، ولم يمنعهم كون رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين أظهرهم من أن يطبقوا فريضة الاجتهاد عمليًّا، ولو صح ما يروّجه البعض من أنهم -رضي الله عنهم- لم يجتهدوا مطلقًا في حياة النبي، لكان الأولى حين سأل النبي: فإن لم تجد في كتاب الله وفيما قضى به رسول الله؟ أن يجيب الصحابي معاذ بن جبل، قائلًا: «أعود إليك يا رسول الله، لتقضي في الأمر، ثم أذهب إلى أهل اليمن لأنقل إليهم قضاءك»، ولكنه رضي الله عنه قال دون تردد: «أجتهد رأيي ولا آلو» (أي لا أقصر في الاجتهاد، ولا أترك بلوغ الوسع فيه).
وهنا يُداهمنا سؤال غاية في الأهمية: ما فائدة اجتهاد الصحابة ورسول الله بينهم والوحي يأتيه من السماء؟ ألم يكن الأولى بهم كلما داهمتهم الخطوب وحاصرتهم النوازل أن يتركوا الأمر برمته للنبي، صلى الله عليه وسلم؟ وتتلخص الإجابة في أن اجتهادهم -رضي الله عنهم- كان ثمرة طبيعية لتلك البذرة التي زرعها رسول الله في نفوسهم، وهي إعلاء قيمة العقل؛ فقد ربّى النبي أصحابه على الاجتهاد، وحثهم على بذل الوسع في إدراك الحكم الشرعي في كل نازلة تنزل بالمجتمع الإسلامي، دون خوف من عقاب شرعي إذا جانب المجتهد الصواب في الرأي، وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم: «من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد»، وفي رواية أخرى: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ»([8]).
ونهى النبي -صلى الله عليه وسلم- أصحابه عن تعطيل الاجتهاد أو تركه، وغلّظ الوعيد لمن أراد الركون إلى التقليد، وذلك حين قال: «لَا تَكُونُوا إِمَّعَةً، تَقُولُونَ: إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَحْسَنَّا، وَإِنْ ظَلَمُوا ظَلَمْنَا، وَلَكِنْ وَطِّنُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَنْ تُحْسِنُوا، وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَا تَظْلِمُوا»([9])، وفي هذا يقول ابن قيم الجوزية: «وقد كان أصحاب الرسول -صلى الله عليه وسلم- يجتهدون في النوازل، ويقيسون بعض الأحكام على بعض، ويعتبرون النظير بنظيره»([10]).
ثم جاء التدرج التشريعي المُعتاد؛ لينقل الصحابة وعموم المسلمين الذين يأتون بعدهم، من مرحلة الاجتهاد في العهد النبوي، إلى الطريق الأمثل لتجديد الخطاب الديني بعد وفاته -صلى الله عليه وسلم- وانقطاع الوحي، ويتمثل ذلك فيما رواه الصحابي الجليل أبوهريرة رضي الله عنه، أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال: «إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا»([11])، ولو كان الخطاب الديني لا يحتاج إلى تجديد (كما يزعم البعض) لما أكد هذا الحديث النبوي على «بعثة المجدد»، بل إن النبي -صلى الله عليه وسلم- حسم الأمر في جملتين؛ الأولى: «إن اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ»، والثانية: «يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا»، أي أن التجديد سنة إلهية، وفريضة دينية، لا يملك بشر تعطيله، أو عدم الاعتراف بمشروعيته، وكونه ضرورة قصوى.
ويتضح من الأدلة التي عرضناها فيما سبق؛ أن الاجتهاد هو الطريق الأوحد لتجديد الخطاب الديني، وأنه أصل من أصول الإسلام، وفرض شُرِعَ بنص قرآني، وقول وإقرار نبويَّان، وتطبيق عملي من الصحابة (نعرض نماذج منه في المبحث الثالث من هذه الدراسة)، كما يتبيّن لنا أيضًا وبنصّ القرآن والسنة فساد مذهب «فارضوا التقليد»، و«رافضوا التجديد»، وأن مقولات مثل: «ليس في الإمكانِ أبدعُ ممَّا كانَ»، «ولم يَتركِ الأوَّلُ للآخِر شيئًا»؛ هدفها تغييب العقل الإسلامي، وإبقاء الشعوب ساكنة تعجز عن مواكبة أي تقدم.
ولا تقف خطورة مذهب «فارضوا التقليد»، عند حد تعطيل «فرض الاجتهاد»، وهو ما يؤدي إلى جمود الفكر الديني، وتذيل المسلمين لركب الأمم، وتركهم فريسة للجهل والخرافات وفتك المستجدات بهم، بل إن ما يتعدى هذه الخطورة الكارثية هو أن من يُفتي تقليدًا (مجرد الفتوى وليس الاجتهاد)، أو نقلًا عن السابقين، دون مراعاة أحوال الناس ومستجدات عصرهم، فقد ضلَّ وأضلَّ وجنى على الدين، وهذا ما أكده ابن قيم الجوزية، بقوله: «من أفتى النَّاس بمجرَّدِ النُّقولِ من الكتبِ على اختلافِ عرفهم وعوائدِهم وأزمنتِهم وأمكنتِهم وأحوالِهم وقرائنِ أحوالِهم؛ فقد ضلَّ وأضلَّ، وكانَت جِنايتُه على الدِّين»([12]).
وما يهمنا في هذا المقام هو: هل بالفعل اجتهد الصحابة للحدِّ الذي جعلهم يعطلون العمل بحكم مستنبط من نص قرآني قطعي الثبوت والدلالة؟ أو أن اجتهادهم توقف عند حد التجديد في الفروع دون المساس من قريب أو بعيد بالأصول؟ هذا ما سنجيب عنه في الجزء الثاني من هذه الدراسة.
ثَبْتُ الْمَصَادِرِ وَالْمَرَاجِعِ:
[1] - الفكر الديني وقضايا العصر، للدكتور محمود حمدي زقزوق، صفحة 15.
[2] - تعريف الاجتهاد عند حُجة الإسلام أبي حامد الغزاليِّ، الفقيه الأصولي المتكلم.
[4] - اشتراط علم المجتهد بالأدب يرجع إلى أن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين؛ لذلك لا يستطيع أي إنسان تفسير لفظ فيه وهو لا يعرف «ديوان العرب»، وقد أكد الصحابي الجليل عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- هذا المعنى، حين قال: «عليكم بديوان العرب؛ فإن فيه تفسير لكلام ربكم».
[5] - أصول التشريع الإسلامي، للشيخ علي حسب الله: ص 83.
[6] - اختيار المسلمون الذين عاشوا في القرون الثلاثة الهجرية الأولى كنموذج لخيرية الفعل وشرعنته من عدمه، مرجعه الحديث الذي أورده الإمام البخاري في باب فضل الصحابة، وغيره من أئمة الحديث، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «خَيْرُ الْقُرُونِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ».
[7] - أخرجه أبو داود (3592)، والترمذي (1327).
[8] - أخرجه البخاري، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، من حديث عمرو بن العاص -رضي الله عنه-.
[9] - رواه الترمذي في سننه، عن الصحابي حذيفة بن اليمان رضي الله عنه.
[10] - كتاب «أعلام المُوقَّعين» لابن قيم الجوزية - الجزء الأول.
[11] - أخرجه أبو داود (4291) واللفظ له، والحاكم في المستدرك: 4 / 522، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقال السخاوي في المقاصد الحسنة: 203: «إسناده صحيح».
[12] - كتاب «أعلام المُوقَّعين» لابن قيم الجوزية (3/ 66).











