اجتهاد القدماء والمعاصرين.. فرضية التجديد وإشكالية التقليد (2 - 4)
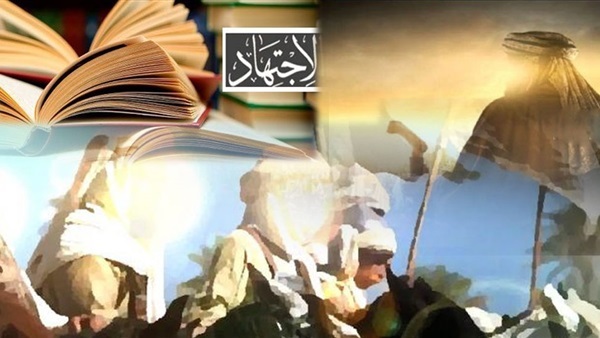
تناولنا في الجزء الأول من دراسة: «اجتهاد القدماء والمعاصرين.. فرضية
التجديد وإشكالية التقليد»، تعريف الاجتهاد وشروطه وحكمه وأقسامه، وبيَّنا بالأدلة
القطعية أنه أصل من أصول الشريعة الإسلامية، وضرورة دينيَّةٌ وشرعيَّةٌ وحياتية،
ولا يجوز تعطيله بأي حالٍ من الأحوال، ثم أوردنا الإجابة عن عدد من الأسئلة المهمة،
والتي كان أبرزها: لماذا سارع القدماء إلى الاجتهاد؟ وما فائدة اجتهادهم -رضي الله
عنهم- ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- بينهم والوحي يأتيه من السماء؟
وفي الجزء الثاني من هذه الدراسة، نعرض نماذج من اجتهاد الصحابة،
لنرى هل كان اجتهادهم موقوفًا على الفروع أم أنه تجاوز ذلك إلى الأصول؟ وهل بالفعل
عطَّل صحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أحكامًا مستنبطةً من نصوص قرآنية قطعية
الثبوت والدلالة؟ وما الفوائد التي عادت على المجتمع الإسلامي من هذا الاجتهاد؟
وغير ذلك من النقاط المهمة التي نوردها في السطور التالية.
المحور الثالث: نماذج من اجتهاد المسلمين الأوائل
نحن أمام وقائع وقضايا كثيرة جدًّا، جميعها تبرهن أن الاجتهاد كان
ديدنًا أصيلًا في نفوس الرعيل الأول من المسلمين، وفي عرضنا لهذه النماذج
الاجتهادية التي حفظت للمجتمع الإسلامي بقاءه، وأهَّلته لتبوؤ سُدة الريادة حينذاك،
يجب أن نراعي العامل الزمني؛ لأن اجتهاد الصحابة مرَّ بمرحلتين زمنيتين، الأولى:
اجتهادهم في حياة رسول الله، والثانية: اجتهادهم عقب وفاته صلى الله عليه وسلم.
◄ المرحلة الأولى: اجتهاد الصحابة في حياة رسول الله
الوقائع الدَّالة على أن الصحابة -رضي الله عنهم- اجتهدوا في حياة رسول
الله -صلى الله عليه وسلم- أكثر من أن تُحصى، وهي على أقسام ثلاثة: فإما أن يُقر
النبي الرأي الذي تفتقت عنه عقلية المجتهد، وإما أن يرده مع توضيح الصواب، وإما أن
يتمسك الصحابي برأيه المردود من قِبل رسول الله، وهنا يفصل بينهما الوحي، وسنكتفي
في عرضنا لهذه المرحلة بذكر نموذج لكل قسم من هذه الأقسام:
(1) تعطيل العمل بحكم آية الطهارة:
في غزوة ذات السلاسل (وقعت في العام الثامن الهجري بين المسلمين،
وقبيلة عربية تُسمى «بني قضاعة»)، كان عمرو بن العاص -رضي الله عنه- قائد جيش
المسلمين، وعقب انتهاء المعركة وهو في طريق العودة إلى المدينة المنورة، أصيب
بجنابة من أثر احتلام، فلما استيقظ من نومه وجد الماء باردًا جدًّا فرفض أن يغتسل
خوفًا من الموت، وتيمم وأمّ أصحابه في الصلاة.
وحينما عاد القوم إلى رسول الله سألهم عن أحوالهم، فأخبروه بما كان من
أمر عمرو بن العاص واحتلامه، وتيممه وصلاته من غير اغتسال، فقال صلى الله عليه
وسلم: «يا عمرو، صليتَ بأصحابك وأنت جُنب؟! قال: نعم يا رسول الله، إنِّي احتلمتُ
في ليلةٍ باردةٍ شديدةِ البرد، فأشفقتُ إنِ اغتسلتُ أن أَهْلَكَ، وذكرتُ قولَ الله
عزَّ وجلَّ: «وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا»
(النساء: 29)، فتيمَّمتُ ثم صلَّيتُ، فضحكَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ولم
يَقُلْ شيئًا»([1]).
واجتهاد عمرو بن العاص، في هذه المسألة، لم يكن في فرع من الفروع بل
كان في ركن من أركان الإسلام، وهو الصلاة، حيث عطّل حكم آية الطهارة التي يقول فيها
الله عز وجل: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ
وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا
عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا..» (النساء: 43)، مقدمًا وجوب الحفاظ على
النفس، وهو في هذا الاجتهاد أدرك أن الإسلام دينُ عقل وليس دين جمود، وأنه جاء ليُسعد
أتباعه لا ليشقيهم، وليحفظ عليهم حياتهم لا ليهلكهم، وقد أقر رسول الله -صلى الله
عليه وسلم- الرأي الاجتهادي الذي تفتقت عنه عقلية هذا الصحابي الجليل.
(2) اجتهاد مردود:
النموذج الثالث الذي نستشهد به في عرضنا لهذه المرحلة، هو «اجتهاد
مردود»، بذل خلاله الصحابي عمار بن ياسر -رضي الله عنهما- وسعه لاستنباط الحكم،
ولكن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يُقر الرأي الذي توصَّل إليه، وبيَّن له الصواب.
يقول عمار بن ياسر رضي الله عنهما: بعثني رسول الله صلى الله عليه
وسلم في حاجة، فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت
النبي فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض
ضربةً واحدةً، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه([2]).
(3) الصلاة على المنافقين:
شاهِدُنا الثاني نموذجٌ مضيء من الاجتهاد؛ رسول الله -صلى الله عليه
وسلم- تأهب للصلاة على عبدالله بن أبي بن سلول (رأس المنافقين)، وعمر بن الخطاب
-رضي الله عنه- يقف أمامه (حائلًا بينه وبين القبلة)، في محاولة لإثنائه عن هذا
الفعل، ولا شك في أن هذا جو ديمقراطي اجتهادي، لكنه ليس أعظم ما في هذا المشهد؛ إن
الأكثر عظمة هو نزول نص قرآني بعد هذه الحادثة يؤيد ما ذهب إليه «بن الخطاب»،
ويُلزم النبي (وهو المعلم الأول للأمة الإسلامية) وجميع المسلمين بالنزول على
اجتهاد هذا الصحابي الجليل، ولنقرأ القصة كما رواها صاحبها:
عن عبدالله بن عباس، قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: لما مات عبدالله بن أُبي بن سلول، دُعي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للصلاة عليه، فقام إليه فلما وقف عليه يريد الصلاة تحولت حتى قمت في صدره.. فقلت: يا رسول الله، أعلى عدو الله عبدالله بن أُبي القائل يوم كذا وكذا وكذا –يعُدُ أيامه–، قال (يُقصد عمر): ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- يبتسم، حتى إذا أكثرت عليه، قال (يقصد النبي): «أَخِّر عني يا عمر، إني قد خيرت فاخترت، قد قيل لي: «اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ» (التوبة : 80) لو أعلم أني لو زدت على السبعين غَفَر له لزدت»، قال (يقصد عمر): ثم صلى عليه ومشي معه، فقام على قبره حتى فرغ منه، قال: فعَجَبٌ لي وجرأتي على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والله ورسوله أعلم، فوالله ما كان إلا يسيرًا حتى نزلت هذه الآية: «وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ..» (التوبة : 84) إلى آخر الآية، قال: فما صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعده على منافق ولا قام على قبره حتى قبضه الله([3]).
ونحن هنا أمام اجتهادين، أحدهما «نبوي»، والثاني «عمري»؛ فصلاة رسول
الله على «عبدالله بن أُبي بن سلول»، كانت اجتهادًا في فهم قوله تعالى:
«اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ
مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ..»، ومحاولة إثنائه -صلى الله عليه وسلم- عن
هذه الصلاة، كانت اجتهادًا أدى إلى فهم مغاير لنفس النص من قبلِ عمر بن الخطاب
-رضي الله عنه-، وقد فصَّل الوحي بين المجتهدين، وأيَّد ما ذهب إليه «بن الخطاب»:
«وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَىَ
قَبْرِهِ..».
◄ المرحلة الثانية: اجتهاد الصحابة بعد وفاة النبي (صلى الله عليه وسلم)
تجدد الأحداث وكثرة النوازل في حياة الناس سنة إلهية، والدينُ
الإسلامي حثَّ أتباعه على مواكبة هذه المستجدات بما يلائمها من تشريعات تضمن مناسبة
الإسلام لكل زمان ومكان، وهذا ما قام به الصحابة -رضي الله عنهم- على أكمل وجه عقب
وفاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، حيث انقطاع الوحي، وغياب المُعلم الأول،
ولدينا في هذه المرحلة نماذج اجتهادية كثيرة، وقد آثرنا اختيار ثلاثة منها، جميعها
عُطلت فيها أحكام شرعية كانت مستنبطة من نصوص قرآنية قطعية الثبوت والدلالة:
(1) منع سهم المؤلفة قلوبهم:
المؤلفة قلوبهم، هم قوم
دخلوا في الإسلام، ولكن إيمانهم كان ضعيفًا، وكان لهم تأثير في مجتمعاتهم، ومن بين
هؤلاء: أبوسفيان بن حرب، ويعلى بن أمية، لذلك فرض لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
سهمًا في الزكاة من أجل تأليفهم.
ولم يكن سهم الزكاة الذي
فرضه النبي -صلى الله عليه وسلم- للمؤلفة قلوبهم، نابعًا من اجتهاد نبوي أو ضرورة
سياسية، إنما كان تشريعًا مستنبطًا من نص قرآني قطعي الثبوت والدلالة، يقول الله
تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ
عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ» (التوبة : 60)، وظل رسول الله يُعطي هؤلاء سهمهم من الزكاة طيلة
حياته.
ولما تولى أبو بكر الصديق
-رضى الله عنه- الخلافة، جاءه اثنان من المؤلفة قلوبهم هما: «الأقرع بن حابس»،
و«عيينة بن حصن»، يطلبان أرضًا، فكتب أبو بكر لهما بما أرادا، فمرّا على عمر، فرأى
الكتاب فمزّقه، وقال: هذا شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيكما إياه ليتألّفكما، والآن قد أعزّ الله الإسلام وأغنى عنكما، فإن ثبتما على الإسلام، وإلاّ
فبيننا وبينكما السّيف، فرجعا إلى أبوبكرٍ، فقالا: ما ندري، الخليفة أنت أم عمر؟
فقال: هو إن شاء، ووافقه.
ولم يُنكر أحد من الصحابة
على عمر بن الخطاب، اجتهاده الذي منع فيه المؤلفة قلوبهم من الحصول على سهمهم كأحد
مصارف الزكاة الثمانية، معطلًا بهذا تشريعًا مستنبطًا من نص قرآني قطعي الثبوت
والدلالة، وتعطيل العمل بالحكم هنا لا يعني بأي حالٍ من الأحوال نسخ النص؛ لأن
الآية القرآنية: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ
وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ
اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» ثابتة، والمسلمون يتعبدون بها من يوم أن
نزلت، وسيظل الأمر هكذا حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وكل ما حدث هو تعطيل العمل
بالحكم الوارد فيها؛ لأن في هذا التعطيل مصلحةً للمجتمع الإسلامي.
(2) إسقاط الجزية:
الجزية، هي ضريبة مالية
كان يدفعها أهل الكتاب للمسلمين مقابل حمايتهم والدفاع عنهم من أي اعتداء خارجي،
إضافة إلى إعفائهم من المشاركة في صفوف الجيش (بديل الجندية)، حتى لا يضطروا إلى
الانخراط في جيش يخوض معارك لا تقنع بها ضمائرهم ولا ثقافتهم، وقد يعرضون أنفسهم
للهلاك من أجل دين لا يؤمنون به.
والجزية فرضت بنص قرآني
قطعي الدلالة والثبوت، يقول الله تعالى: «قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ» (التوبة: 29)، وقد
حصلها النبي من أهل الكتاب في حياته، وكذلك فعل خلفاؤه، وعدد من حكام المسلمين.
ولأن الحكم يدور مع علته
وجودًا وعدمًا، كما يقول الأصوليون؛ فإن العلة من فرض الجزية هي تعهد المسلمين
والتزامهم الكامل بالدفاع عن أهل الكتاب (أرواحًا، وممتلكات، وكنائس، ومعابد)،
وإعفاؤهم من المشاركة في صفوف جيش يرفع راية الدولة الإسلامية التي كان يحكمها على
طول امتدادها حاكم واحد، وعقب سقوط الخلافة العثمانية (1924) واستقلال كل دولة
إسلامية بحكم ذاتي، وحلول المواطنة بديلًا لأي مصطلحات أخرى أُسقطت الجزية بصورة
نهائية، لأن علتها زالت، وهذا هو التدرج العام لإسقاط هذه الضريبة؛ إلا أن هذا
التدرج تخلله حالات استثنائية، أعمل فيها المجتهدون عقولهم، وعطَّلوا العمل بالحكم
المستنبط من نص قرآني قطعي الثبوت والدلالة، لزوال العلة.
ونذكر من هذه الحالات
الاستثنائية، إسقاط الخليفة الثاني عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- الجزية عن «بني
تغلب»؛ لأنهم عربُ يأنفون دفع مثل هذه الضريبة، فأسقطها عنهم وقبِلَ بأن يدفعوا
صدقة مضاعفة، وقد دفعه لهذا الاجتهاد، سببان، الأول: حقن الدماء؛ لأن الإسلام دينُ
سلام وليس قتالًا، كما يزعم بعض المتشددين، والثاني: أنه أَمِن شرهم، لأنه خاف أن ينشقوا
عن الدولة، وينضموا إلى صفوف الروم (يقصد بهم الإمبراطورية الرومانية الشرقية أو
البيزنطية التي كانت عاصمتها القسطنطينية).
وحين فتح أبوعبيدة بن
الجراح، الشام، (وكان هذا في عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب أيضًا) أخذ الجزية
من أهل حمص، الذين تمسكوا بدينهم، واشترطوا عليه أن يحميهم من الروم الذين كانوا
يضطهدونهم وينزلون بهم أشد صنوف العذاب، وعقب وقت قصير قرر المسلمون الانسحاب من
الشام حين علموا أن «هرقل» أعد جيشًا قوامه 240 ألف فارس (كان الجيش الإسلامي
قوامه حينذاك 32 ألف فارس)، وفي هذه اللحظة ردَّ «أبوعبيدة»، كل أموال الجزية التي
حصَّلها رجاله من الحمصيين، وقال لهم: «لقد اشترطتم علينا أن نحميكم، وإنا لا نقدر
على ذلك، ونحن لكم على الشرط إن نصرنا الله عليهم».
ومضت قرون طويلة
والمسلمون يُحصِّلون الجزية من أهل الكتاب مقابل حمايتهم والدفاع عنهم وإعفائهم من
المشاركة في الجيش، إلى أن جاء محمد سعيد باشا، والي مصر (كان القطر المصري في ذلك
الوقت ولاية تابعة للخلافة العثمانية)، وحطَّ في يناير من العام 1855م، الجزية عن
النصارى المصريين، مقابل مشاركتهم في الدفاع عن أراضي الوطن (الانخراط في صفوف
الجيش المصري)([4])،
فكانت مصر بهذا أول بلد إسلامي يُعطِّل العمل بفريضة الجزية المستنبطة من نص قرآني
قطعي الثبوت والدلالة، لأن مصلحة الناس والوطن استوجبت هذا التعطيل، ثم عمم الحكم
على جميع البلدان الإسلامية منذ عام 1924م، وذلك عقب سقوط الخلافة العثمانية.
المحور الرابع: ثمرة اجتهاد السابقين
ما ذكرناه من نماذج
اجتهادية، كان قليلًا من كثير؛ فالرعيل الأول من المسلمين، بدءًا من عصر الصحابة
وصولًا إلى القرن العاشر الهجري، آمنوا بالاجتهاد إيمانًا راسخًا كما ذكرنا من
قبل، وعدُّوه ضرورة قصوى وفريضة قدموها على كل فريضة في حياتهم، وكُتب التاريخ زاخرة
بالآلاف من النماذج التي تؤكد ما نذهب إليه، ومن الخطأ أن نسلم بتلك الرواية
التاريخية التي تذهب إلى أن الحاكم العادل عمر بن عبدالعزيز، المُكنى بـ«سادس
الخلفاء الراشدين([5])» من شدة عدله، هو
أول مجدد في الإسلام، وأن الإمام محمد بن إدريس الشافعي، هو المجدد الثاني، فهؤلاء
ومع تسليمنا التام بأن كل واحد منهما مجدد عصره؛ إلا أنهما حبات مضيئة في عقد بدأ
نظمه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المجددون الأوائل في الإسلام.
ولاجتهاد المسلمين الأوائل
ثمرات متعددة، وفوائد أكثر من أن تحصى، أهمها:
(1) تجديد الخطاب الديني
اجتهاد الرعيل الأول من
المسلمين جدَّدَ الخطاب الديني بالحد الذي حقق غاية الإسلام الكبرى، وهي أنه دينٌ صالح لكل زمان ومكان، فلم نقرأ في السيرة النبوية أو تاريخ الخلفاء الراشدين، وما
تلاه من تاريخ إسلامي وصولًا إلى القرن العاشر الهجري، أن الدين كان عائقًا في
حياة المسلمين، أو أن قضية مستجدة بقيت معضلة استعصى حلُّها على فقهاء كل عصر من تلك
العصور، بما نتج عنه حيرة ومعاناة ألمَّت بالمجتمع الإسلامي حينذاك.
(2) ديناميكية النص:
النص الإسلامي ديناميكي،
أي أنه مُشبع بالحركة والنشاط والحيويّة بما يجعله ملائمًا لكل زمان ومكان،
والديناميكية هنا لا تعني التفريط أو الإفراط، والمسلمون الأوائل أدركوا أن
الإسلام لا يعرف شيئًا يُسمى بـ«جمود النص»؛ فالتشريعات والأحكام المستنبطة من
نصوص قطعية الثبوت والدلالة، هدفها إسعاد الناس، والتماشي مع مقتضيات الزمان
والمكان، ولذلك فإن كل حكم زالت علته لا مانع من أن يصبح هو والعدم سواء، وكل
مستجد لا تفي النصوص بتوضيحه يصبح استحداث حكم له فرض عين على الفقهاء:
«الشَّريعةُ صالحةٌ لكُلِّ زمانٍ ومكانٍ، ونُصوصُ الكِتابِ والسُّنَّةِ محدودةٌ،
وأحوالُ النَّاسِ ووسائِلُهم إلى مَقاصِدِهم مُتجدِّدةٌ وغيرُ محدودةٍ، ولا
يُمكِنُ أن تَفِيَ النُّصوصُ المحدودةُ بأحكامِ الحوادثِ -المتجدِّدةِ غيرِ
المحدودةِ- إلَّا بالاجتهادِ»([6]).
(3) الإعلاء من شأن العقل:
إعلاء المسلمين الأوائل،
من قيمة العقل، ودفعهم إياه للقيام بمهامه التي خلقه الله من أجلها، يجعلنا نؤكد
«أنهم عَدُّوا العقل وحيًا»، ولا شك في أن هذه الثمرة أَثْرَتْ الفكر الديني، وجعلت
أنهاره متدفقة باستمرار، لا يعرف الركود إليه طريقًا، وصنعت مجددين ومفكرين
ومصلحين في كل بقعة من العالم الإسلامي.
(4) مجتمع متحضر:
المجتمع الإسلامي في عهد
الصحابة، ومن جاء بعدهم من المسلمين حتى القرن العاشر الهجري، كان متحضرًا في كل
مناحي الحياة، وهذا الأمر ليس بغريب على أناس جعلوا العقل قائدًا، واتخذوا من
العلم سبيلًا في تشييد بُنيان حضارة إسلامية قادت ركب الأمم لحقب زمنية طويلة، كان
العالم كله ينهل منها المعارف بمختلف صنوفها.
(5) مجتمع بلا تطرف([7]):
وهذه هي الثمرة والفائدة
الأهم لاجتهاد الأوائل، فالعمل الدؤوب بفريضة الاجتهاد يُنتج فكرًا وخطابًا دينيًّا
متجددًا، ومن ثَّم تُبنى عقول يعجز «مسيسو الدين» أو المتطرفون ومن شابههم على
اختراقها، أو حتى بث سمومهم على مقربة منها، والتاريخ يُثبت أن المجتمع الإسلامي في
قرونه العشرة الأولى لم يعرف هذه الجماعات والتنظيمات الإرهابية التي نراها اليوم.
وحتى الخوارج([8])، ذلك الفصيل الذي
اتخذ من السياسة ذريعة لممارسة التطرف، حين أرادوا أن يشرعنوا أفعالهم برداء الدين
لَفِظَهم المسلمون، لأن العقول وقتها كانت محصنة بفكر إسلامي صحيح يتدفق إليها من
تجديد فقهاء عرفوا قيمة الاجتهاد.
(5) مجتمع بلا خرافات
مجتمع اجتهد علماؤه، ونتج
عن اجتهادهم فكر وخطاب ديني متجدد، فحصنوا العقول بالعلم والتعددية
والإيمان بقيمة الاختلاف واحترام الآراء وغير ذلك من ضروريات التحضر؛ مجتمع مثل
هذا هل يُعقل أن يكون فيه موضع قدم لدجال أو مشعوذ؟ بالتأكيد لا.
هذا كان حال السابقين؛ فماذا
عن المعاصرين، هل اجتهدوا بالفعل؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، فهل كان اجتهادهم تجديدًا
أم تقليدًا؟ هذا ما نجيب عنه في الجزء الثالث من هذه الدراسة.
ثَبْتُ الْمَصَادِرِ وَالْمَرَاجِعِ:
[1] - رواه البخاري، كتاب التيمم: باب إذا خاف الجنب
على نفسه المرض، أو الموت، أو خاف العطش تيمم، ورواه أبو داود في سننه.
[2] - متفق عليه، واللفظ لمسلم.
[3] - رواه البخاري (1366)، والنسائي (1965)، والترمذي
(3097).
[4] - كتاب «الجزية في مصر» من عام 1713 – 1854 م
- د. أيمن أحمد محمود.
[5] - الخلفاء الراشدون هم: أبوبكر الصديق، ثم عمر
بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم عليُ بن أبي طالب، وأخيرًا الحسن بن علي لأنه بويع
رسميًّا بالخلافة، وظل خليفة للمسلمين 7 أشهر وقيل 8 أشهر إلى أن تنازل عنها لمعاوية
بن أبي سفيان، وكانت خلافة «الحسن» راشدة، لأنها مكملة لمدة الخلافة الراشدة التي أخبر
عنها النبي في الحديث الذي رواه الترمذي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «الخلافة
في أمتي ثلاثون سنة ثم ملك بعد ذلك».
[6] - أصول التشريع الإسلامي، للشيخ علي حسب الله:
ص 83.
[7] - المقصود هنا هو التطرف الديني.
[8] - فرقة خرجت على خليفة المسلمين الرابع علي بن
أبي طالب، بعد قبوله التحكيم مع معاوية بن أبي سفيان، وعُرفوا بالمغالاة في معتقداتهم
الدينية وبالتكفير.











