كتاب يناقش انهيار حركات «الإسلام السياسي» في الوطن العربي
الخميس 28/يونيو/2018 - 02:08 م
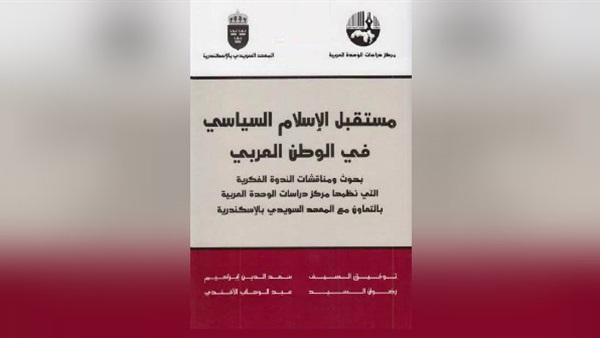
مستقبل الإسلام السياسي في الوطن العربي
طه علي أحمد
ما إن وصل تيار «الإسلام السياسي» إلى صدارة المشهد، في أعقاب ما عُرِفَ بالربيع العربي، وما صاحبه من انهيار سريع وصدامات واسعة بالمجتمع، إلا وثار جدل واسع حول مستقبل ذلك التيار.
ورغم أقدمية هذا الجدل، فإن خطورته هذه المرة ترجع إلى تفرد التجربة الأخيرة لتيار الإسلام الحركي؛ حيث وصل التنظيم الأم «الإخوان» إلى السلطة في البلد الذي شهد نشأتهم.
وتتمثل أحد الإسهامات التي اتصلت بمستقبل ظاهرة الإسلام الحركي، في كتاب صادر عن «مركز دراسات الوحدة العربية» ببيروت، بالتعاون مع المعهد السويدي بالإسكندرية بعنوان: «مستقبل الإسلام السياسي في الوطن العربي».
ينطلق الكتاب من المدخل التاريخي لقراءة مسار ظاهرة الإسلام الحركي؛ حيث يكتسب ذلك المدخل أهمية خاصة عند محاولة فهم نشأة حركات الإسلام السياسي؛ فقد اشتهرت ظاهرة نشأة تلك الحركات مع انتهاء الحرب الباردة، وإخلاء ساحة للولايات المتحدة، وبلغت ذروة الحضور الإرهابي مع أحداث سبتمبر 2011، التي أعلنت عن حضور البديل المستجد في ثنائية الصراع الدولي، وهو الإسلام الحركي، في إطار ما عُرف بالحرب على الإرهاب.
يتضمن الكتاب بحوث ومناقشات ندوة فكرية نظمتها الجهتان المصادرتان للكتاب، شارك فيهما مجموعة من خبراء علم الاجتماع السياسي، وهم (توفيق السيف، ورضوان السيد، وعبدالوهاب الأفندي)، إضافة لسعد الدين إبراهيم، وهو ما أثرى الرؤى والأطروحات المقدمة من قِبَل المشاركين الذين أجمعوا على أن أبرز ما تحتاجه المجتمعات العربية اليوم، هو قيام وحدة تاريخية بين التيارات الرئيسية، والتوافق على قواسم مشتركة لبناء المشروع الوطني والقومي والنهضوي، المرتكز على التعددية السياسية والحريات الأساسية.
وتتنوع عناصر المشروع النهضوي العربي بعناصرة الستة: الوحدة العربية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، والتنمية المستقلة، والاستقلال الوطني والقومي، والتجدد الحضاري، وتصل إلى كونها برنامجًا مشتركًا للتيارات الرئيسية (القومي الديمقراطي، الإسلام الديمقراطي، اليسار الوحدوي، الليبرالي الوطني).
ويطرح المشاركون تساؤلات حول الدين والسياسة، والحركات الإسلامية عمومًا والإخوان خصوصًا، والمواطنة؛ حيث يرتبط السؤال الأول ببعدين هما تسييس الدين، وتديين السياسة، أما بالنسبة للحركات الدينية والإخوان فنتيجة للصراع الطويل مع السلطات على مرِّ تاريخها، تعلمت أن تكون دفاعية، وأن تكون نظرتها للداخل أكثر من الخارج، ومن ثَمَّ باتت أقل تقبلًا للنصح من التيارات الإصلاحية داخلها، وأقل استجابة للنقد من خارجها، وكانت كلما حققت تقدمًا زاد الحصار والقيود على الأصوات الناقدة بداخلها، باعتبار أن ذلك يُهدد تماسكها وبقاءها.
وتُمثل المواطنة أحد التحديات الكبرى التي تُواجه تيارات الإسلام الحركي، لاسيما على مستوى معالجتها؛ حيث تنطلق تلك الجماعات من اعتبار أن المجتمع السياسي الأساسي، هو ما يتكون أفراده من «المسلمين الملتزمين» على النحو الذي يتفق مع توجهاتهم.
ويذهب الإسلامويون المتشددون إلى أن في وسعهم ممارسة سياسة العلة بطلب «موطن» خاص بهم يهاجرون إليه، أو في وسعهم اتباع توصية سيد قطب، منظر الإخوان، في البداية من النقطة صفر، ومحاولة جلب الناس واحدًا تلو الآخر، حتى يتسنى لهم تشكيل أكثرية في المجتمع.
والقول بأن الرئيس المعزول محمد مرسي أو حكم الإخوان لم يُمارس الاستبداد السياسي، لأنه لم تتح له الفرصة، أو حتى لم يمتلك الأداة لذلك، قول ينقصه الدقة، إذ شهدت فترة حكم الإخوان ممارسات «فاشية» من الجماعة، وصلت إلى حد قتل المعارضين، خاصة خلال أحداث الاتحادية 2012، وكذلك الحال بالنسبة للإعلان الدستوري.
ولم تقتصر الرؤى المشاركة على الحالة المصرية، بل اتسعت لتشمل الحراك الذي شهدته العديد من الدول العربية، لاسيما الخليج العربي، فمستقبل الإسلام الحركي بالسعودية على سبيل المثال ليس مشرقًا أو مبشرًا، ذلك أن الإسلامويين السعوديين، خلافًا للحال في تونس ومصر، لا يعتبرون في نظر الجمهور نقيضًا أيديولوجيًّا أو سياسيًّا، أو بديلًا موضوعيًّا من النخبة الحاكمة.
ويذهب سعد الدين إبراهيم إلى أن ما حدث في مصر خلال 2013، هو بداية الخسوف لظاهرة الإسلام الحركي، لكنه يعود ليؤكد أن ذلك الخسوف لا يعني انتهاء تأثير الإسلام الحركي، في المجتمعات التي يعيش فيها، فينتقي المؤلف كلمة «خسوف»، بما يعني أن ظاهرة الإسلام الحركي أوشكت على الغروب، لكنها يمكن أن تشرق ثانية؛ فالإخوان يمثلون التنظيم السياسي الأول في مصر الحديثة، الذي لجأ إلى العنف المسلح لفرض إرادته على المجتمع والدولة، كما أنهم مارسوا دور «الضحية»، على قاعدة أن من استهدفهم هو عدو للإسلام والوطن، ومن ثم فإن أخطر ما تمخضت عنه تجربة حكم الإخوان في مصر، تتمثل في مسألتين: الأولى، اتجاه الإخوان إلى تقليص مصر، لتكون مجرد «إمارة» في دولة الخلافة، ثم ينتهي إلى أن هذا الحلم غير قابل للتحقيق في القرن الحادي والعشرين، أما المسألة الثانية فهي صدام الإخوان مع الدولة والمجتمع، وهو ما أفقدهم بعض الشعبية التي كانوا يحظون بها.
ويلاحظ أن رؤية «خسوف الإسلام الحركي» اتسمت بدرجة واضحة من الابتكار؛ حيث ترتبط بمفهوم الدورات التاريخية، ذلك أن هذا الخسوف لا يؤثر في مكان الدين في المجتمع وثقافته العامة؛ حيث تتجذر مكانة الدين في الثقافة العامة للمجتمع المصري، وهو ما عزز وطأة الضربة التي تلقاها الإسلام السياسي في مصر والعالم العربي.
وعلى الرغم من تنوع حركات الإسلام السياسي (الحركي) وسهولة نشأتها أينما كانت فإنها تلتقي جميعها على نماذج سلفية تتمحور حول تصورات الخلافة القديمة، وعلى الرغم أيضًا من محاولة هذه الحركات الاستفادة من منجزات التقدم، فإنها تبدو وكأنها لا تنتمي إلى هذا العصر، سواء على مستوى المقولات أو الأفكار.
وأخيرًا فإن الصيرورة التاريخية توضح أن ثمة انقطاعًا بين الإسلام التاريخي والحركات الحديثة التي أرادت أن تُعيد بناء نموذج إسلاموي، وهو ما يبرز حالة من التوازن بين شرعية التأسيس، وشرعية المصالح، وهي الإشكالية التي تتضمن العناصر التالية:
1) التوتر بين الإسلام الإصلاحي الذي توجته إنجازات محمد عبده الفكرية والعلمية.
2) التوتر المتمثل بالتأرجح بين الهويات الوطنية والقومية والإسلامية والعالمية، وما يستتبعه من الاعتراف بشرعية الدولة الوطنية أو عدمه.
3) التأرجح بين العمل السياسي والنقابي والعنف المسلح، وهو ما يؤدي إلى إرباك جماهير تلك الحركات.
4) التوتر بين فقه السياسة بالمعني الحديث للكلمة وفقه الشريعة، والتي تنطوي على تضييق المجال الرحب للنشاط السياسي والعلمي والاجتماعي.
5) التوتر الذي تؤدي إليه التحالفات التنظيمية القائمة على المنفعة المباشرة للتنظيم.
6) المفهوم المختلف للعلاقة بين الأمير والمريد، وتوقع الطاعة العمياء من الأعضاء، وتدفق الممارسات الديمقراطية بعد الثورات العربية.
7) غياب أي مفهوم للعمل الاقتصادي والنظر إلى الاقتصاد على نحو جامد لا يستطيع الانتقال بالمجتمع عبر توافر فرص العمل والارتقاء بالبحث العلمي والإنتاج الثقافي.
على أي حال، تبدو إشكالية مستقبل الإسلام السياسي (الحركى) إحدى ميادين البحث التي اتسعت خلال الآونة الأخيرة، فلم تكن الأطروحات الواردة بهذا الكتاب هي الوحيدة، بقدر ما اتصلت بعدد من الإشكاليات العميقة، والتي لم تقتصر على علاقة «الإسلاميين» بالسلطة بقدر ما تطرقت إلى مساحة أكبر شملت علاقتهم بالمجتمع.
وأخيرًا، فإن الانحدار، والخسوف، والانهزام، والانكسار، وغيرها من العبارات الدالة على النهاية، بدت أبرز ما يميز الخطاب النقدي لمستقبل تيارات الإسلام السياسي.











